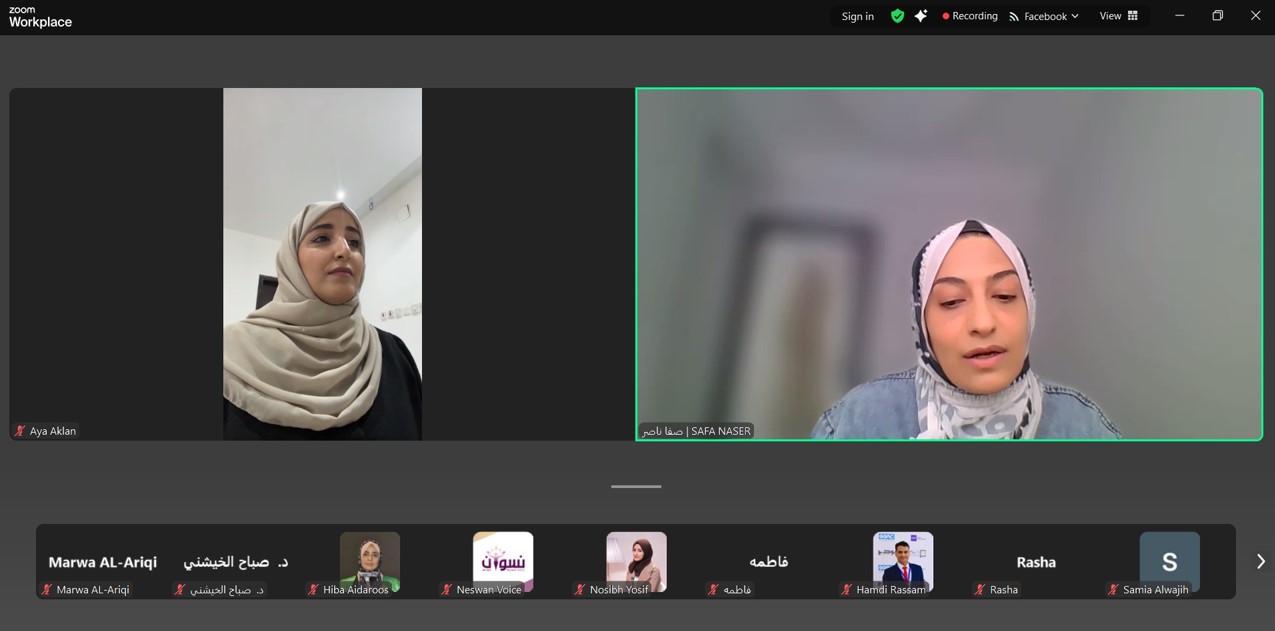مروى العريقي – نسوان فويس
نظمت منصة “نسوان فويس”، اليوم السبت، جلسة حوارية عبر الاتصال المرئي (زوم)، بُثت مباشرة على صفحة المنصة عبر فيسبوك، تحت عنوان: “تعاطي وسائل الإعلام اليمنية مع قضايا العنف الأسري”.
تأتي هذه الجلسة في ظل تجدد ظاهرة العنف الأسري في اليمن، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذه القضية. أدارت الجلسة الصحفية الشابة آية خالد، المهتمة بقضايا المرأة والطفل.
التغطية الإعلامية للعنف الأسري في اليمن
تحدثت الدكتورة صباح الخيشني، أستاذ الإعلام المساعد بكلية الإعلام جامعة صنعاء، عن دور الإعلام كبناء تنموي للمجتمع ولترابط الأسرة نفسياً وجسدياً، مشيرة إلى أنه الوسيلة الأهم لتشكيل الرأي العام.
تطرقت الدكتورة الخيشني إلى الأسباب الرئيسية لضعف تناول الإعلام اليمني لقضايا العنف الأسري، ملخصة إياها بسطحية تناول موضوعات العنف الأسري في الإعلام المحلي بأشكاله كافة (صحافة تقليدية ورقمية، إذاعة، تلفزيون) إذ تُقدم كأخبار مقطوعة دون متابعة لتطورات الحدث.
وأشارت الخيشني إلى ثاني الأسباب وهو حساسية القضايا والتخوف، حيث تُعد قضايا العنف الأسري من المواضيع الحساسة التي نادراً ما تُدرج ضمن السياسات الاستراتيجية للمؤسسات الإعلامية.
وبحسب الخيشني يعود هذا إلى تخوف الإعلاميين، خاصة الصحفيات، من تجاوز “المحرمات” الاجتماعية والثقافية، مما قد يُعرضهم للتهديد أو الانتقام. لذا، يحرص الإعلام اليمني على تجنب تناول الموضوعات التي قد تُثير الاستياء الاجتماعي، أو تُخالف التقاليد المحافظة، أو تُعتبر تدخلاً في شؤون أسرية خاصة.
وأوضحت الخيشني بأن السبب الثالث يتمثل في ضعف أساليب المعالجة الإعلامية، إذ أن التناول الإعلامي لقضاي العنف الأسري غالبًا ما يعزز الصور النمطية، مثل تصوير المرأة دومًا ضحية ضعيفة لا حول لها ولا قوة، بينما تغيب قصص تمكين النساء أو تحررهن من دائرة العنف.
وأكدت الخيشني بأن الصراعات السياسية والحرب أثرت بشكل كبير ورئيسي على أولويات الإعلام. تُركز التغطية حالياً على قضايا الحرب، السياسة، والأمن، مما يُهمش ما عداها من قضايا كالعنف الأسري، قضايا المرأة والطفل، تنمية الشباب، والتعليم.
وأضافت لم تكتفِ الحرب بتدمير البنية التحتية والاقتصاد، بل تسببت في تفكك العلاقات الأسرية، وتوسيع دائرة العنف الأسري، وارتفاع معدل الجريمة.
تُشير الدراسات إلى أن هذا التفكك الاجتماعي والاقتصادي أدى إلى ظهور العنف الأسري كظاهرة يومية، مع تزايد معدلات العنف ضد النساء والأطفال.
كما أدى تصاعد النزاع إلى إضعاف مكانة النساء والفتيات، مما نتج عنه تآكل شبه تام في آليات حمايتهن وزيادة تعرضهن للعنف وسوء المعاملة.
من بين 4.3 مليون نازح في السنوات الثلاث الماضية، حوالي نصفهم من النساء، و27% منهن دون سن 18 عامًا.
وأشارت الخيشني إلى جملة من التحديات التي تواجه الإعلام اليمني في معالجة قضايا العنف الأسري، منها: القيود الثقافية والدينية، بالإضافة إلى الرقابة السياسية والأمنية ففي بعض المناطق، تُعتبر تغطية قضايا العنف الأسري مخالفة للتوجهات الرسمية، مما يُعرض الصحفيين للرقابة أو التضييق، كما أن ضعف التنسيق مع منظمات المجتمع المدني يقلل من استفادة الإعلام من التقارير والإحصائيات التي تُصدرها منظمات حقوق الإنسان، ولا يُحسن توظيفها في صياغة حملات إعلامية توعوية.
موضحة أن نقص البيانات الرسمية والإحصاءات الموثوقة تجعل المعالجة الإعلامية قائمة على التقدير الشخصي أو الشهادات الفردية، إذ لا توجد قاعدة بيانات وطنية شفافة حول حالات العنف الأسري.
واختتمت الخيشني حديثها بمقترحات عملية لتطوير التناول الإعلامي، تشمل: إعداد أدلة تحريرية مهنية حول كيفية تناول قضايا العنف الأسري، وإطلاق برامج تدريبية للصحفيين حول التغطية الأخلاقية والحقوقية، وتشجيع الصحافة الاستقصائية لفضح القوانين أو الأعراف التي تُشرعن العنف، بالإضافة إلى بناء شراكات مع المنظمات النسوية ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي، وتخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية موجهة تناقش القضية من مختلف الزوايا (القانونية، النفسية، الاجتماعية)، وكذا تمكين الضحايا من إيصال أصواتهم بطريقة آمنة وإنسانية.
غياب التشريعات الداعمة لحماية الضحايا
تطرقت الدكتورة هبة عيدروس، الخبيرة القانونية والباحثة الحقوقية في قضايا المرأة، إلى أسباب العنف الأسري، مركزة على الجوانب التشريعية والقانونية.
وقالت عيدروس: تُبرر الثقافة المجتمعية سيطرة الرجل على المرأة، وتعتبر “تأديب الزوجة أو الابنة” شأناً عائلياً لا يُحاسب عليه. كلمة العيب والوصمة تمنع النساء من التبليغ أو طلب المساعدة، مؤكدة على أنه لا يوجد قانون خاص يُجرم العنف الأسري بشكل واضح.
وأضافت: تُعاني آليات إنفاذ القوانين الموجودة من قصور، فضلا عن أنه لا تتوفر آليات حماية كافية مثل أوامر الحماية ودور الإيواء المتخصصة.
وتطرقت عيدروس للحديث حول قلة الوعي القانوني وغياب الوعي التعليمي، قائلة: تُعاني نسبة عالية من النساء من نقص الوعي بحقوقهن وكيفية التبليغ عن العنف. كما يغيب الوعي التعليمي حول هذه القضايا لدى الطلاب.
وأشارت إلى وجود ضعف عام في التثقيف المجتمعي حول الآثار النفسية والاجتماعية للعنف.
آليات الحماية من العنف الأسري
لتحقيق حماية كافية، قدمت الدكتورة عيدروس رؤية للآليات المأمولة:
إقرار قانون شامل للحماية يتضمن تعريفاً واضحاً ومحدداً للعنف الأسري، يحدد أشكاله، ينص على عقوباته، ويحدد التدابير الوقائية.
بالإضافة إلى تعديل القوانين القائمة التي تُبرر أو تُخفف العقوبة في حال كان الجاني من الأسرة، مثل “تأديب الزوجة”.
وتجريم الأذى الشامل سوى الأذى النفسي والاقتصادي والجنسي داخل الأسرة، ليشمل الإجبار الزوجي على العلاقة الزوجية، المنع من التعليم، والحرمان من الموارد.
وتفعيل أوامر الحماية الفورية تُصدرها المحكمة أو الشرطة لحماية الضحية فوراً دون الحاجة لدعوى جنائية كاملة.
وكذا ضمان سرية الإجراءات، وتجريم الوساطة العرفية ومنع تسويتها خارج القضاء، وإنشاء شرطة متخصصة بالعنف الأسري بقيادة نسائية مدربة على التعامل مع الناجيات.
وتوفير مراكز استقبال ودور إيواء آمنة لتوفير حماية فورية للنساء والفتيات المعرضات للخطر، بالإضافة إلى تفعيل خطوط تعمل على مدار الساعة وتقدم الدعم النفسي والقانوني الأولي.
تعامل جمهور السوشيال ميديا مع قضايا العنف
من جانبه قدم الدكتور محمود البكاري، أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة تعز، تحليلاً لتعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع قضايا العنف الأسري، مشيراً إلى أنها تُشكل ساحة مزدوجة:
بحسب البكاري هناك قسم من الجمهور يُبرر العنف: يضم من يدعمون أو يتغاضون عن الممارسات العنيفة، وغالباً ما يستندون إلى مفاهيم اجتماعية أو ثقافية خاطئة لتبرير سلوكياتهم.
وقسم أخر يُناهض العنف بمنظور حداثي، تسعى هذه الفئة إلى الدفاع عن الضحايا ومحاربة العنف. ومع ذلك، قد تتحول هذه المساعي، دون قصد، إلى منزلق يؤدي إلى تشهير الضحية، خاصة عندما يتم تداول تفاصيل القضية بشكل واسع.
ووفقا للبكاري فكلما زادت حملات الدفاع غير المدروسة، كلما زادت احتمالية تعرض الضحية للمزيد من العنف أو الوصم الاجتماعي نتيجة لتداول قصتها علناً.
يُظهر هذا التناقض حاجة ماسة إلى تأهيل وتوعية واسعة النطاق للأفراد، سواء كانوا ناشطين أو جمهوراً عاماً، حول كيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري على وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية، وبما يخدم الضحية فعلاً دون تعريضها لمخاطر إضافية. بحسب البكاري.
القواعد المهنية لتغطية قضايا العنف الأسري في الإعلام
ركز هذا المحور الذي قدمته الباحثة المستقلة صفا ناصر، على الجانب الأخلاقي والمهني لتغطية قضايا العنف الأسري، مؤكدةً على أن “العنف يُعدي”، وبالتالي يجب عدم نشر تفاصيل قد تؤثر سلباً على الضحايا أو المجتمع، أو تُشجع على تكرار العنف.
أساسيات التغطية الصحفية
ولضمان تغطية مهنية وأخلاقية ومؤثرة، تشدد ناصر على أنه يجب على الصحفي أن يطرح على نفسه الأسئلة الجوهرية التالية قبل الشروع في النشر: لماذا يجب أن أغطي هذه القضية؟ ما هي القيمة الخبرية والأهمية المجتمعية؟ ما هو هدفي من النشر؟ هل هو رفع الوعي، المطالبة بحق، فضح فساد، أم تقديم حلول؟
وبخصوص نشر صور الضحايا، لفتت ناصر الأهمية إلى حصول الصحفي على الإذن المسبق من أهل الضحية للنشر، والموافقة الصريحة عليها، مؤكدة على تمويه الصور للحفاظ على كرامة الضحايا وخصوصيتهم.
وتطرقت ناصر في حديثها على أهمية اختيار المصطلحات التي يجب أن يستخدمها الصحفي المناسبة وغير المسيئة، وتجنب أي لغة قد تُزيد من وصم الضحايا.
كما شددت على التخلي عن أي تحيزات شخصية لضمان الموضوعية. داعية إلى التفكير في العواقب المستقبلية للنشر على حياة الضحايا وسمعتهم وسلامتهم النفسية.
مشيرة إلى ضرورة فهم ماذا يعني العنف الأسري بكل أبعاده. فالصحفي ليس مجرد ناقل للخبر؛ بل يجب أن يُنمي مهاراته في هذا الجانب. يجب أن يسأل نفسه باستمرار: “هل أساهم في حل المشكلة أم أزيد من تعقيدها؟” فالهدف الأسمى هو المساهمة في الحماية، التوعية، والدفع نحو التغيير الإيجابي.
نحو إعلام يمني أكثر مسؤولية
تُظهر هذه الجلسة الحوارية بوضوح أن معالجة وسائل الإعلام اليمنية لقضايا العنف الأسري لا تزال تواجه تحديات عميقة، تتراوح بين القيود المجتمعية والتشريعية، وتأثير الصراعات، وصولاً إلى التعامل المعقد لوسائل التواصل الاجتماعي.
هذه التحديات تُعيق الإعلام عن أداء دوره كاملاً في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الضحايا.
إن مسؤولية التصدي للعنف الأسري هي مسؤولية جماعية. وعلى الإعلام، سيما الإعلام الجديد منه، كونه أداة قوية لتشكيل الرأي العام، أن يُدرك دوره المحوري في هذا النضال.
فبتناوله الواعي والمسؤول لهذه القضايا، لا يُساهم فقط في فضح الانتهاكات، بل يُعزز الحماية، ويُشجع على المطالبة بالحقوق، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، حيث تجد المرأة والطفل فيه الأمن والاحترام الذي يستحقانه.